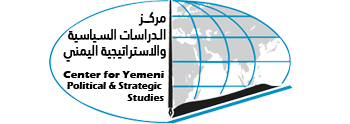
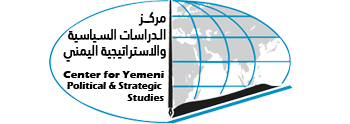
مقدمة
إذا صح أن يؤرخ للوحدة بين الألمانيتين بلحظة هدم جدار برلين الشهير، فإن الوحدة بين جمهورية اليمن الديمقراطية والجمهورية العربية اليمنية لا يمكن أن يؤرخ لها بإزاحة براميل الشريجة بوصفها "جدار برلين اليمن" إذ أن هذه اللحظة لم تمثل بطبيعة الحال إلا جولة إضافية أخرى من حرب باردة خمد أوارها بهدم جدار الشراكة في 7/7/1994م ليودِّع اليمنيون حقبة "وفاق الفرقاء" المبشرة باجتراح آفاق وطنية بلا حروب داخلية مدلجين في حقبة "فراق النظراء" الباعثة على خيبة أمل وطنية مقرونة بانسداد أفق شديد القتامة.
إن 7/ 7/ 1994م في سياق المخاض الوحدوي، هو تاريخ شديد الشبه بأغسطس 1968م في سياق المخاض الجمهوري شمالاً، فمن تماس هذين التاريخين انـبـثـقــت وحدة وجمهورية قائمتان على الغلبة ودحض التعدد المتعاضد على قاعدة المشتركات الوطنية، وتمثيل إرادة ومصالح الشعب بمنأى عن الاستحواذ والتبعية العابرة للفضاء الوطني.
لقد أثرَّ هذان التاريخان المفصليان على نحو عميق وجلي في سلسلة الأحداث التي أعقبتهما كما في الذاكرة الجمعية لليمنيين سلبا ً وإيجاباً، بحيث تصعب مقاربة تطورات المشهد السياسي اليمني اللاحقة بإغفال أثرهما فيها كاستجابة مباشرة ومناوئة لمنعطف 1968م الذي اعتبر انحرافاً بالجمهورية الغضة وطرية العظم، عن مسارها الوطني واستفراغها من مضامينها الثورية، نشأت منظمات وفصائل العمل المسلح اليسارية والقومية، المناهضة لسيطرة قوى الإقطاع والانتهازية وأصحاب الولاءات غير الوطنية.
ففي 1969م تشكلت ـ على سبيل المثال ـ منظمة طلائع الفلاحين، وبعدها بزمن وجيز برزت منظمة المقاومون الثوريون كما مثلت حركة 13 يونيو التصحيحية 1974م بقيادة ( الشهيد إبراهيم الحمدي ) التي استولت على السلطة بانقلاب أبيض، أبرز ردات الفعل الوطنية المناوئة لانحرافات 1968م والرامية لإعادة دفة الجمهورية إلى مجراها الوطني وخضم آمال الجماهير التواقة لعدالة اجتماعية في ظل سيادة وطنية ناجزه.
وقد حظيت حركة 13 يونيو وزعيمها بالتفاف وتأييد شعبي واسع لا سابق له في تاريخ اليمن المعاصرـ ولا تزال واقعة اغتيال الشهيد إبراهيم الحمدي من قِبَل أدوات المخابرات السعودية وبإشراف مباشر من ملحقها العسكري في صنعاء برهاناً حياً على بشاعة الأدوار والأساليب التي تنتهجها قوى الهيمنة والاستكبار العالمي والرجعية العربية لزنزنة اليمن قراراً وتوجهاً وشعباً وتراباً داخل سياج نفوذها، كما وبرهاناً حياً على طبيعة الأثمان التي يتعين أن يقدمها الشرفاء والوطنيون من أبنائها على مذبح الكفاح الطويل في سبيل الانعتاق من نير الهيمنة وأطواق الوصاية والارتهان.
من السهل كذلك أن نلمس لانحرافات 7/ 7/ 1994م تداعيات شبيهة بتلك التي أعقبت انحرافات 1968م، سحبت نفسها على طول الفترة الزمنية الممتدة من 1994م مروراً بمحطات 2007، 2011، 2014 الساخنة، واستمراراً إلى اللحظة الراهنة والمفتوحة على احتمالات انعتاق وطني باتت مواتية أكثر من ذي قبل بفعل ثورة سبتمبر التي وضعت البلد والمنطقة على تخوم زمن مغاير.
انحسار النقيض اليساري والقومي وبقاء الحاجة الشعبية لنقيض
بمقدورنا القول إن تاريخ اليمن المعاصرة، هو تاريخ العثرات ومحاولات النهوض من العثرات، تاريخ خُفوت جذوة الحلم في كينونة وطنية برافعتي السيادة والعدالة الاجتماعية ومركزية الإنسان الفاعل، ثم اتقاد جذوة هذا الحلم بالتناوب في خضم متغيرات موضوعية وذاتية داخلية وخارجية تعيق في الغالب تحقق تلك الكينونة لكنها لا تجعلها مستحيلة ولا تنفي الحاجة إليها والحاجة لاستمرار النضال في سبيل تحققها.
أنجز اليمنيون الاستقلال السياسي من نير الاحتلال العثماني، بيد أنهم وقعوا تحت نير الانكفاء القُـطري والاستبداد، ثم كسروا جدران العزلة باحثين عن الضوء والعدالة الاجتماعية، فوقعوا تحت نير التبعية والحكم بالوكالة وإقطاع مراكز القوى، ثم كافحوا ضد هذه فانحسرت الظروف الإقليمية والدولية المواتية للكفاح وتكسرت أجنحة التجربة الوطنية الاشتراكية المحاصرة في جنوب اليمن - الذي كان قد انتزع استقلاله من أيدي الاحتلال البريطاني في 1967م - وهرب المناضلون شمالاً وجنوباً في 22 مايو1990م إلى فخ وحدة اندماجية بلا أفق واضح، أفضت في نهاية المطاف إلى طيِّ صفحة الحركات والأحزاب اليسارية والقومية نهائياً، ووقوف قوى الإقطاع و الكمبرادورية على أنقاض قرابة أربعة عقود من النضال، لتشرب نخب انتصارها في 7/ 7/ 1994م كقوى محلية وكيلة للقطب المنتصر عالمياً.
لقد كان الصراع من حيث طبيعته وأطرافه صراعاً بين نقيضين يريد أحدهما لليمن أن تتطور وطنياً وقومياً في سياق تحرري سيادي مقرون بعدالة اجتماعية، تتيح للدولة القُطرية التفاعل ايجاباً مع القضايا المركزية العربية والقضايا الإنسانية العادلة على المصاف ألأممي، دون أن تثلم استقلاليتها وتتحول كينونتها الوطنية إلى مجرد كيان وظيفي يحارب ويسالم ويصادق ويعادي بالوكالة عن طرف إقليمي أو دولي، كما ويتيح لها داخلياً إدارة عملية تنموية متوازنة ضامنة لتكافؤ فرص الحياة ونمو قوى الإنتاج في كنف اقتصاد موجه يوفر لرأس المال الوطني فرص شراكة وحماية مقيدة بالمسؤولية الاجتماعية بمنأى عن الاستغلال والاحتكار وعلى أساس هذه المحددات يلتئم البناء الفوقي السياسي ويحظى بالمشروعية.
وعلى هذه الضفة من الصراع كانت معظم الحركات اليسارية والقومية والوطنية شمالاً وجنوباً تقف، حتى مع كون بعض فصائل اليسار الماركسي قد انتهج خطاً اعتسافيا ً للواقع الموضوعي حين ذهب بطموح بناء المجتمع الاشتراكي حد التأميم في بلد غير صناعي وخراجي الاقتصاد.
في المقابل فقد التأمت على الضفة الأخرى من الصراع كل قوى الإقطاع القبلي والديني وقوى الموالاة للاستعمار والرجعية العربية، وباتت سلطة صنعاء عقب 1968م إطاراً طبقياً يضم شمل هذه القوى سواءً تلك التي ثبتت سيطرتها في الشمال على مقاليد الحكم الجمهوري بعد إفراغ الثورة من مضامينه التحررية، أو تلك التي فقدت مصالحها في الجنوب عقب الاستقلال والجلاء، ونظراؤها من انتهازيين ورجعية مقنعة تقاطرت في فترات لاحقة تباعاً لتنضوي في سلطة صنعاء.
إن حرب صيف 1994م هي "أم المعارك" وملحمة الملاحم في سياق الاشتباك الأيديولوجي التاريخي بين النقيضين الآنفين، وخاتمة حقبة ستشهد تحولاً في المسمَّيات على مصاف الصراع لكن جوهر الصراع وطبيعته ستبقى ذاتها، النضال المحفوز بالحاجة المصيرية الملحة الى كينونة وطنية مستقلة ومقرونة بعدالة اجتماعية، لم تتحقق بعد.
لقد اعتقدت القوى المنتصرة في 1994م خطأً أنها أجهزت على هذه الحاجة وعلى هذا المطلب الموضوعي، وأنه صار بوسعها أن تنعم بحقبة مديدة من السيطرة بلا منغصات.
تبعاً لذلك ستعيد رسم الأدوار السياسية وتسمية المكونات التي تضطلع بها وستتولى فرز المشهد تحت سطوة حقيقة وبسط لسيطرتها الانفرادية الناجزة، إلى ما هو شرعي وما هو غير شرعي، ومن هو الحاكم ومن هو المعارض، وستنجم عن ذلك مشهدية سياسية ديكورية هي خليط متعدد من حيث المسميات والأدوار، لكنه أحادي متجانس من حيث تعبيره حصراً وبالجملة عن مصالح (كارتيل السلطة الكمبرادورية المنتصرة) ومصالح مركز الهيمنة القطبية، وفي خضم هذه المشهدية الزائفة لن يحضر الشعب ومصالحه بوصفه أساساً للعبة الحكم والمعارضة، إنما مجالاً حيوياً لسجالاتها المفضية في جلِّـها إلى تسويات لا تخصه ولا تـثـمِّـن وجوده تسويات هي حصيلة احتكام أطراف السجال كوكلاء لطاولة الأصيل الدولي بتبعية كاملة، تتهافت خلالها هذه الأطراف للظفر بانحيازه إلى صفها ودرجات مرتفعة نسبياً من الحظوة لديه في مقابل خصومها، وتتسلح في سبيل ذلك بقابلية فذة لتقديم التنازلات أياً كانت.
ـ يقول "الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر" في معرض وصفه لأطراف الصراع الناشب في أغسطس 1968م: "لقد أصبح الصراع بين الجمهوريين من جهة واليساريين من جهة أخرى" (المذكرات)
ويعترف في جزء آخر من مذكراته بأن "التجمع اليمني للإصلاح الحزب الذي رأسه حتى وفاته تأسس بإيعاز من علي صالح مطلع الفترة الانتقالية 1990م، لينهض بوظيفة المعيق والمشوش على كل اتفاق يضطر صالح للالتزام به صورياً أمام شريكه في إنجاز الوحدة الاندماجية الحزب الاشتراكي" إبان تلك الفترة كان تجمُّع الإصلاح ورئيسه الأحمر لاعباً سياسياً مناهضاً بشدة لـلوحدة مع من يصفهم بالشيوعيين الملاحدة، كما وللــدستور 1990م العلماني حد موقف الإصلاح منه وفقط عندما أجهزت سلطة صنعاء بزعامة الإخوان والأفغان اليمنيين على مؤسسات الدولة الجنوبية والحزب الاشتراكي في 1994م، باتت الوحدة مقدسة وشرعية لدى الأحمر وحزبه.
وفي 2002م بلغت درجة رضا الإصلاح حد مباركة الاقتران بخصمه اللدود الاشتراكي في "تحالف المشترك" فماذا حدث ليسوغ هذه التحولات الدراماتيكية في الموقف من " شيوعيي 1990م الملاحدة إلي شركاء الوحدة.
"لقد تابوا وراجعوا موقفهم من الدين"، هكذا يفسر الأحمر تبدُّل موقفهم من الاشتراكي، في رده على سؤال قناة الجزيرة عام 2006م حول "مفارقة انضواء الحزبين في ائتلاف واحد" بتجاوز تأويل الصراع بالدين ـ إلى ما هو عليه في سياقه المادي، نجد أن الحزب الاشتراكي كان قد تخلَّى عن راديكاليته الأيديولوجية في وقت مبكر منتصف ثمانينيات القرن الفائت، لذا فإن سخط خصومه إبان الفترة الانتقالية للوحدة، لم تكن تستهدفه على مصاف الأيديولوجيا.
لقد سلمَّ الاشتراكي بالديمقراطية التعددية وبالحلول والمفاهيم الرأسمالية للاقتصاد وما ينبغي أن يكون عليه، وتقدمت حكومته بمشروع إصلاحات اقتصادية ملتزمة رأسمالياً بمحددات صناديق الإقراض الدولية؛ وفي 1993م، وجه مذكرة رسمية تتضمن طلب العضوية في مؤتمر الاشتراكية الدولية.
إلا أنه رغم كل ذلك ظلّ موضع مؤامرات وسخط الخصوم إذ كان إلى حينها لا يزال شريكا ً يتمتع بالسلطة على ترسانة عسكرية وإدارية تنتظمها مؤسسات الدولة الجنوبية، وكان ذلك سبباً كافياً لاستمرار مخاوف خصومه منه ومكائدهم له وفي حقيقة الأمر، فإن هذه المكائد لم تكن تعمل محلياً بمعزل عن كنف رغبة قطبية ورعاية من قبل دوائر واشنطن الدبلوماسية والاستخباراتية على الأرض، فبالنسبة لقطب منتصر، شرع منذ 1991م في هندسة نظام عالمي جديد؛ فإن مؤسسات الدولة الجنوبية كانت تعني أكثر من مجرد هياكل إدارية جامدة ومحايدة، إنها رغم تواضع التجربة الاشتراكية وعثراتها بناء أيديولوجي عقائدي، يتحتم تقويضه حجراً وبشراً.
يقول "ديفيد نيوتن" وهو ديبلوماسي أمريكي مخضرم كان يعمل سفيراً لدى اليمن إبان ثورة سبتمبر 1962م ولاحقاً نائب سفير مطلع السبعينيات: "وقفنا إلى جانب اليمن خلال منعطفين مهمين؛ مرة عبر اعترافنا بالجمهورية الوليدة، وأخرى بتوفير غطاء سياسي مكَّن صالح من خرق القرارين الأمميين "924؛ 931" بوقف إطلاق النار في حرب 1994م، حماية للوحدة جاء ذلك في سياق حديث صحفي أدرته معه في (واشنطن 2011م).
نتيجة ً لهذا العون الأمريكي الذي يقر به "نيوتن" انتهى الحال بعشرات الآلاف من الكوادر والكفاءات الجنوبية، وتحديداً العسكرية والأمنية منها خارج نطاق الفاعلية مشردين على أرصفة الداخل والخارج وخسرت اليمن تجربة مؤسسية فارقة في متناول اليد كان يمكن البناء عليها بيسر وتعويض افتقار الشطر الشمالي شبه التام إلى بناء مؤسسي حديث يلبي حاجته لدولة نظام وقانون، لم تبرح حبراً على ورق.
تتيح لنا إضاءة مرتجعة على مشهد ما بعد أغسطس 1968م رصد تداعيات مماثلة للأنفة، فقد استُهدفت الألوية والوحدات العسكرية التي هي حصيلة مؤازرة مصر الناصرية لدولة اليمن الغضة، بالتجريف وتسريح واغتيال كوادرها بوصفهم رافداً اجتماعياً محدثاً تمخضت عنه الثورة شذوذاً على تراتبية سيطرة تقليدية سرعان ما استعادت قواها العافية إثر نكسة حزيران وانحسار المؤازرة المصرية، وبفعل مدد سعودي - بالغ السخاء - جعل من اليمن منطقة نفوذ متواتر للمملكة منذ ذلك الحين.
لقد كانت تصفية النقيض الحامل لبذرة المشروع الوطني الملتحم بالشعب - إذاً - هدفاً لا إمكانية لتكريس سيطرة قوى الهيمنة وأدواتها المحلية في اليمن بغير إنجازه، إلا أن نجاح هذه القوى في الإطاحة بالأدوات السياسية والثورية الحاملة لهذه البذرة، لم يكن يعني بأية حال نجاحاً في الإطاحة بالعوامل الموضوعية التي تمد هذه البذرة بالحياة وتخصب حوامل ثورية بديلة لها أكثر التحاماً بشعبها وترابها، وأوفر إرادة وقدرة على قضّ مضاجع قوى السيطرة بالوكالة المطمئنة لهوان الشعب وجبروت الهيمنة القطبية السرمدي.
مشهدان نقيضان
كانت الساحة اليمنية عقب 1994م، ممهدة ومثالية تماماً بالنسبة لسلطة توّجت - للتو - حقبة من الصراع امتدت لقرابة أربعة عقود، بانتصار كاسح على خصومها التاريخيين، وآلت إليها مقاليد السيطرة بلا منازع. . بينما كانت هذه الساحة على الجانب الشعبي جحيماً حقيقياً تنوء الغالبية المسحوقة فيه بعبء تلال فواتير وتبعات باهظة هي حصيلة كل تلك الحقبة من الصراع مضافاً إليها النتائج الكارثية لإعادة الهيكلة الاقتصادية والإصلاحات السعرية والخصخصة التي دشنت مطلع العام 1991م بالتزامن مع عودة حوالي "مليون مغترب يمني" رُحِّلوا من سوق العمل الخليجية كردّ فعل على موقف الحكومة اليمنية المتعاطف مع العراق إبان أزمة احتلال الكويت وحرب الخليج الثانية، وفي السياق ذاته عوقبت اليمن بالحرمان من مساعدات ومنح مالية كانت تمثل رافعة رئيسة للموازنة الحكومية والاقتصاد عموماً. وإذا كان ذلك قد جعل من الشارع الشعبي في الشمال ضحية بائسة، فإن الشارع الجنوبي كان الضحية الأكثر بؤساً لعواصف التداعيات المتلاحقة تلك.
ــ لقد وجد غالبية الجنوبيين أنفسهم فجأة غرباء في فوضى سوق بلا دولة وعلى تراب كان مؤمماً بالكامل وأصبح مصادراً بالكامل، وأفاقوا من وهم الشراكة الندية على واقع القنانة وفقدان الوزن، ومن حلم الوحدة على كابوس الضمّ والإلحاق ومن الإمساك بصولجان الحكم الجزئي، على حمل نير استحقاقات الهزيمة.
بموازاة هذا الحضيض الشعبي المكتظ بالمنغصات والمستتب الخراب، كان ثمة منغصَّان اثنان يؤرقان استرخاء رؤوس السلطة المنتصرة، تجسدا في: الحاجة لبلورة محددات مناسيب النفوذ وكُنْهِ الأدوار والصورة المستقبلية للحكم، كما وحاجة صالح من جهة وآل الأحمر من جهة أخرى كأبرز مركزين فيها، إلى توطيد العلاقة بواشنطن للتعويض عن موقف سعودي داعم خَسِره الأول على خلفية أزمة حرب الخليج الثانية، في مقابل سعي الآخر لاستقطاب المزيد من الدعم الخليجي وكسب ود واشنطن، عبر الانخراط في لعبة المعارضة وسوق الاستثمار بمظهر ليبرالي منفتح ومتقبل لثقافة التعدد المتعايش وموجبات الديمقراطية بالمفهوم الليبرالي، وينتهج الاعتدال على مصاف الدين.
تبعاً للعبة الاستقطابات النشطة والمحمومة تلك نشأت مشهدية سياسية داخلية هي عبارة عن احتشاد قوى ثانوية وهامشية منقسمة على محك الموالاة حول مركزي السلطة الآنفين، وحضر الشعب -فقط - بوصفه مجالاً حيوياً لسجالات الطرفين اللذين اختلفا غالباً على كل شيء واتفقا دائماً على ضرورة تغييبه كإرادة وآمال بامتداد مسار السجالات والتسويات بينهما. . في الأثناء كانت الأحزاب اليسارية والقومية ولاسيما "الاشتراكي والوحدوي الناصري" أضأل من أن تؤلف رقماً فارقاً في المشهد السياسي، فقاطعت العملية الانتخابية تارةً دون أن تؤثر في مجرياتها بالمقاطعة "مقاطعة الاشتراكي لانتخابات 1997 البرلمانية"، أو خاضتها فحصدت حضوراً صفرياً من خوضها، ولاحقاً وجدت نفسها تنزلق داخل دوامات سطوة ونفوذ مركزي السيطرة التقليدية، كإجراء وقائي عوَّلت خلاله على لفت انتباه المجتمع الدولي الراعي للعبة الديمقراطية، إلى ضرورة حلحلة التوازنات الفجة القائمة لصالح تمكينها من حضور فارق نسبياً فيها. أما ثمن ذلك فالمثول غير المشروط لإعادة الصهر في بوتقة المسلمات الأمريكية والتزام مثابر بموجبات الحياة في ظل النظام العالمي الجديد.
لقد تمظهر هذا التجانس المميت في صورة دورات انتخابية تعيد تدوير ذات الوجوه في كل محطة من محطاتها، وتدحض إمكانية الحديث عن نقيض يمثل الإرادة الشعبية في النضال لإنجاز التغيير المنشود وكانت أحزاب ذات رؤى إسلامية تجديدية زيدية ووطنية مدينية مثل اتحاد القوى والحق قد تشكلت باستغلال فضاء ما بعد الوحدة التعددي، وتوازن أحدثه حضور الحزب الاشتراكي في مشهد الحكم، لتقع مجدداً فريسة لنزوع ثأري من قبل خصومها التقليديين ذوي الأيديولوجيا "الجمهووهابية" التي باتت الوحدة قالباً حصرياً لمفاهيمها عقب 1994م على غرار جمهورية 1968م ، وسحب هذا المتغير نفسه على الحزبين الآنفين في صورة تصدعات بنيوية أفقية طالت بناءهما الفوقي حديث العهد بالتأسيس، وتشظت كوادره وأنصاره ومطبوعاته وفقاً لمواقف قياداته من مركزي السيطرة وحرب 1994وفوق ذلك كله من الراعي الدولي للعبتي الديمقراطية والسوق.
ـ وبطبيعة الحال فقد بات "المعهد الديمقراطي التابع للخارجية الأمريكية في صنعاء" محجاً لإعادة تأهيل القيادات الحزبية المعمـِّرة، وتأهيل الشبيبة للنهوض بلعبة معارضة مدجنة كلياً لحزمة يقينيات معيارية قطبية هي من منظور مسوِّقيها "النيوليبراليين" الصيغ المثلى لما ينبغي أن تكون عليه الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد ، في بلدان جنوب الكرة وتكفلت صناديق الإقراض الدولية، بتشخيص مشكلات الاقتصاد المحلي وبلورة الحلول الملزمة وتحديد أوجه وكيفيات إنفاق المبالغ المتحصلة من مؤتمرات المانحين التي تتولى التنسيق لها والإشراف والرقابة على مخرجاتها في ظل غياب كامل لدور وطني على مصاف تقييم طبيعة المشكلات الاقتصادية واقتراح المعالجات، تبعاً للحاجات المحلية وخصوصيات البلد الذي بات بفعل فجاجة التدخلات الدولية وانصياع مكوناته السياسية لها، صلصالاً طيّعاً تشكله أصابع الدائنين والمانحين على نحو ما تريد وترغب، ضمن ما يسميه المفكر سمير أمين "إدارة أزمة الديون" وليس إنهاءها جذرياً.
أصبح لدينا - كنتيجة لذلك - مركز حكم منهمك في استجلاب الديون والمنح كيفما اتفق لتدعيم شرعيته المرهونة بنجاحه في أداء هذا الدور، إذ أن نجاحه على هذا المصاف يعني رضا الراعي الدولي عنه، ما يعني في المحصلة استمراره حاكماً لبرهة مديدة أخرى، في المقابل فإن السعي للتشكيك بأهليته لدى الدائنين ودحض ثقتهم فيه، يبقى الدور الحصري للمعارضة ونجاحُها فيه يعني تبدُّلا ً وشيكاً في توازنات لعبة الحكم، اختمرت حاجة الراعي الدولي إلى الشروع في إجرائها.
كان جلياً - في غياب الآخر النقيض - أن لعبة السجالات غير التناحرية تلك بين مؤتمر حاكم ومشترك معارض لن تطرح ثمرة حقيقية على مائدة الغالبية المفقرة، مهما تعددت دورات السجال وامتدت؛ كما برهنت محطات انتخابات 1997م النيابية، 1999م الرئاسية، 2001م المحلية، 2003م النيابية، و2006م الرئاسية والمحلية غير أن من المهم هنا تأكيد أن غياب الآخر النقيض على مصاف السجالات السياسية الهزلية من 97 الى 2006م، لم يكن - بحتمية الحركة الجدلية للتاريخ - إلا حضوراً بكيفية ورؤية وأدوات أخرى في ساحة أخرى هي بحر الآلام والآمال الشعبية الذي سيـَّـجته وكالات الأرصاد القطبية بالمحاذير وأسلاك الممنوعات الشائكة وكتبت على مداخله بالأحمر العريض خطر ممنوع الاقتراب.
ما كان بوسع الآخر النقيض أن يتخلق إلا في خضم اختلاج الوجع الشعبي ولفح أنفاس المقهورين، وما كان بوسعه أن يتخندق كرؤية ونهج إلا في بؤرة هذه المنطقة المحرمة دولياً، والمهجورة والمحفوفة بالمخاطر.
عندما اضطرم أوار حرب 1994م الظالمة، وقف رجل وحيد تحت قبة البرلمان، حيث لا يجرؤ إلا قلة مغايرة من الرجال على الوقوف، أدان مبررات الحرب التي تذرعت بها السلطة، لكن كلمة الفصل لم تكن حينها - للبرلمان - بطبيعة الحال واستمراراً لموقفه الرافض ذاك دعا إلى لقاء اجتماعي قبلي انعقد وخرج ببيان إدانة واضحة للحرب، كان قدره أن يجابه - لاحقاً - نقمة المنتصر وحيداً وأعزل إلا من موقف وقضية جذريين من حيث انحيازهما للمستضعفين والمسحوقين في مواجهة جبروت استكبار محلي ودولي أذعنت له جلُّ المكونات السياسية والاجتماعية بوصفه قدراً.
كان ذلك الرجل هو الشهيد السيد/ حسين بدرالدين الحوثي الذي استطاع أن يجعل من منبر بسيط ومتواضع في قرية حدودية نائية من قرى الريف الصعدي، حجرَ توازن في مشهد يمني إقليمي مختل، ومصنعاً لطلائع ثورية مؤمنة ستمضي بالثورة إلى أبعد نقطة في تخوم الحلم الشعبي بدءاً من صرخة عزلاء خلف قضبان أقبية وسراديب ضواري الاستكبار وحرَّاس هيكل الأحادية المهيمنة، وليس انتهاءً بتداعي قلاع الإقطاع والعمالة وفرار أبرز رموزها تحت ضربات المقهورين.
أنموذج نضال معولم .... كيف باتت الشبيبة تفكر ؟
في العام 1996م أصدرت الخارجية الأمريكية تقريرها الاعتيادي السنوي حول أوضاع الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة في الشرق الأوسط، وكان أبرز ما ورد فيه تأكيد خلو السجون اليمنية من معتقلي الرأي، وتبرئة ساحتها بخصوص هذا الملف.
جاء ذلك كنتيجة - في الأرجح - لتسوية ملف سجين الرأي الاشتراكي منصور راجح، الذي تصنفه المنظمات الحقوقية المعنية دولياً بأحد أبرز خمسة معتقلين سياسيين في العالم حينها، وبتسوية ملفه ومغادرته السجن إلى منفاه القسري في النرويج، اعتبرت الخارجية الأمريكية اليمن خالية من سجناء الرأي، وكان لها - في واقع الأمر - دوافع أخرى من تحرير هذه الشهادة الجزافية المجافية للواقع. كانت الإدارة الأمريكية ترغب في تسويق اليمن، أنموذجاً أولياً للديمقراطيات الناشئة التي عزمت على تعميمها في "الشرق الأوسط"، وتبعاً لذلك وجهت المزيد من الدعم المادي والمعنوي للتجربة الديمقراطية المحلية في بلد بات مسرحاً مفتوحاً لتنامي معدلات البطالة والتردي الاقتصادي بالتوازي مع تنامي معدلات انتشار المنظمات المتلظية خلف لافتات حقوق الإنسان والحريات العامة بلا ضوابط وطنية.
لم تحل النتائج الكارثية للحرب على الجنوب وتصفية شريك الوحدة والتعددية الحزب الاشتراكي، دون أن تدلي الخارجية الأمريكية بشهادتها عن نظافة أقبية القهر الرسمية، واستمرت في الإشادة بالديمقراطية الناشئة في اليمن، بصورة يفصح عن موقفها الموارب والداعم لنشوب حرب 1994م.
وفيما تعثرت تسوية ملف منصور راجح في زمن قوة الحزب، فإنها أنجزت بسلاسة إثر فقدانه عوامل القوة إذ أرادت الإدارة الأمريكية - على الأرجح - أن تدشن هذه التسوية حقبة سياسية مفتوحة على تعاقدات كونية عابرة للأزمنة المحلية المغلقة والمسكونة بـ "فوبيا الارتياب من مؤامرات امبريالية قادمة من وراء الحدود".
لقد نجح عضو في الحزب الاشتراكي لا يشغل موقعاً قيادياً في تحرير معتقل أخفقت قيادات الحزب في تحريره - فقط باستثمار الفضاء الكوني المفتوح - وعليه فقد بنت الخارجية الأمريكية شهادتها بخلو اليمن من سجناء الرأي، على تقرير هذا الشاب ذاته الذي أسس منظمة ناشطة في مجال الحقوق والحريات استطاعت حشد دعم ومساندة دولية، أثمرت الإفراج عن راجح، واختزل ملف المعتقلين والمخفيين قسرياً في هذه الحادثة المعولمة.
رسخت هذه القضية لدى الشبيبة يقيناً غير عملي عن تحوُّل جذري في كُنْه الصراع تحت تأثير "بروبجندا" مفادها انظروا ماذا يمكن للفرد أن يفعل في ظل كوكب أصبح قرية صغيرة؟.
هكذا فإن القضايا سواءً كانت اقتصادية أو سياسية أو ثقافية، لم تعد تكتسب أهميتها من كونها عادلة وملحة على صعيد واقع البنى الاجتماعية المحلية، بل هي مهمة أو غير ذات أهمية لكونها تحظى أولا تحظى باهتمام الأسرة الكونية في منظور معظم الشبيبة المستلبة لـ "بروبجندا العولمة الأمريكية".
تنسحب هذه المعيارية المعولمة التي تضفي أو تسلب القضايا أهميتها على ملفات قطرية وإقليمية وتتدرج من النظر للسيادة على سبيل المثال؛ لتنتظم مواقف الشبيبة في تقييمها حتى لقضايا مركزية كبرى على غرار الاحتلال الأمريكي للعراق أو الصراع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية.
الحقيقة أن سجون السلطة زمن صدور التقرير الأمريكي الآنف، كانت متخمة بسجناء الرأي على خلفية تهم بنزوع انفصالي أو تأسيس والانخراط في تنظيمات مسلحة تستهدف ما سمي حينها بـقوات الشرعية في الجنوب، أو المشاركة في ندوات خارجية تتآمر على الوحدة والتخابر مع شخصيات محكومة بتهم الخيانة العظمى، وصولاً إلى اعتقالات جماعية نفذتها السلطة بصورة محمومة بدءاً من 1999م في صنعاء وطالت الكثيرين على خلفية ترديد "الصرخة" أو "الشعار الشهير" غير أن إحجام المنظمات الدولية المانحة، عن توفير غطاء لمنظمات مجتمع مدني محلية ترغب في توثيق ورصد تلك الانتهاكات، قد جعلها تمر مرور الكرام في الوقت الذي جرى تضخيم قضايا ترفية، من قبيل (النوع الاجتماعي - الجندر) لتحتل صدارة المشهد الحقوقي وتثير غبار سجالات مدوية بين مؤيدين ومناهضين، استغرقت الرأي العام لسنوات.
في مناخ من الاستلاب كهذا، لم يكن مستغرباً أن تتجاور - بالتزامن - ديمقراطية الاقتراع من جهة وحروب الاقتلاع الست من جهة أخرى، دون أن تدحض إحداهما شرعية الأخرى أو تستشعر المكونات السياسية المنهمكة في سجالات قشورية، فظاعة هذا التناقض.
كان القتل الجماعي يسير على ما يرام وكذلك الديمقراطية، كان الجنوب يبتلع بشراً وتراباً وتـُــسحق آدميته، فيما أهازيج الوحدة تصدح كانت الطائرات الحربية السعودية تفرغ حمولات الموت على رؤوس أطفال "صعدة" المحتمين ببقايا السقوف الطينية والسيادة، وأسراب الدرونز الأمريكية تمشط الأجواء الوطنية وتتسلى يومياً بقتل الأبرياء فيما يشبه معارك "بلاي ستيشن" وكان النشيد الوطني يباهي بالسيادة وعظمة الأمجاد.
كل هذا الخليط من تجاور التناقضات في صورة لعبة اقتراع بين تجانس متعدد من جهة، ولعبة اقتلاع من جهة أخرى تستهدف مكوناً اجتماعياً بذرائع متعددة ولا تصمد كغطاء منطقي للجنازير المنهمكة في القتل، كل هذا الخليط المتناقض كان مؤشراً عملياً على أن النقيض الوطني الشعبي كان يتموضع على الضفة المقابلة للعبة المرايا المتعددة التي لا تعكس سوى الصورة الكلية لمصالح الإمبريالية الأمريكية على هيئة تعددية محلية زائفة لا تصب روافدها في بحر المصالح الوطنية والشعبية ولا تأبه له، فيما كان النقيض هناك، حيث تشير فوهات ترسانة الموت الزاحفة صوب مرابضه وكان يتعين من وجهة نظر سلطات الحرب أن يتم الاجهاز عليه وجوداً وخطاباً، بماكيناتها الحربية وماكناتها الدعائية التي راحت تغزل شتى صنوف الشائعات لتسدلها ستارة سميكة على حقيقة حرب ستتكشف أبعادها تباعاً خلال السنوات التالية لفشل فصولها الستة في إنجاز المنشود منها.
لكن السؤال هو: ما الذي أهَّـل هذا النقيض ليكون نقيضاً؟
ولماذا تخلّق في محافظة قبلية نائيه (كصعدة) ولم يبزغ نجمه من احدى حواضر اليمن الشهيرة ذات البنى الاجتماعية الانتقالية المعروفة بمنسوب من مدينية وثقافة ترشحها نظرياً للنهوض بهذا الدور؟
إنه سؤال يستوجب بحثاً آخر سوى هذه المقاربة التي ستحتفي فقط باقتفاء المحطات الفارقة في سيرورة حراك وطني تمثل خلاله ثورة 21 سبتمبر 2014م اختزالاً شعبياً وطنياً بامتياز لكل محاولات اجتراح أفق الكينونة الوطنية الحلم، بامتداد هذه السيرورة.
بــــــــــــــــروز النقيــــــــــــــض
تميَّـز الشهيد السيد/ حسين بدر الدين الحوثي والشبيبة الملتفة حوله بمقاربة جذرية لطبيعة الصراع الدولي نابعة من صفاء ذهني وسلامة حدس لم تفسدهما المستجدات المتمثلة في انتصار المعسكر الرأسمالي بقيادة أمريكا عقب حقبة الحرب الباردة على المصاف العالمي وانتصار أدواتها كنتيجة على المصاف القطري في 1994م.
ففي الوقت الذي نظرت جل القوى المحلية اليسارية والقومية بالأخص إلى تلك المستجدات بوصفها تبدُّلاً جوهرياً في طبيعة الصراع، سوَّغت بها لنكوصها عن المواجهة والالتحام بالواقع الموضوعي، نظر السيد/ حسين بدر الدين إلى ذات المستجدات بوصفها تبدُّلاً في النتائج والأدوات لا في مواقع الصراع وطبيعته.
وإذاً فإن المواجهة مستمرة وباتت أكثر إلحاحاً اليوم لاسيما وأن أمريكا، التي كانت دائماً على سدة ريادة قوى الاستكبار العالمي باتت بانتصارها هذا أكثر استكباراً.
إلى ذلك فإن حاجة الشعوب إلى العدالة الاجتماعية والخلاص من الهيمنة والسيادة على ترابها ومواردها واستقلال قرارها السياسي، هي حاجة لا يسقطها التقادم بل تحقُّقها، ومادامت لم تتحقق فإن النضال من أجلها ينبغي أن يظل مستمراً.
وإذا كانت معظم القوى السياسية قد أصبحت ترى في أمريكا حليفاً لا غنى عنه في السعي لتحقيق حاجة شعوبهم إلى جملة المطالب الوجودية الملحة تلك، فإن المنطق والمعطيات المادية بامتداد عقود الصراع تقطع بأن ذئب الأمس، يستحيل أن يصبح فجأة صديقاً للحملان.
لقد نبَّـه السيد/ حسين بدر الدين، باكراً إلى أن "القاعدة" ليست إلا واحدة من أخطر الأدوات الجديدة التي لجأت اليها أمريكا في سعيها القديم للهيمنة والانحراف ببوصلة الصراع في العالمين العربي والإسلامي وفتح بوابة واسعة للتمدد بذريعة محاربة صنيعتها الاستخباراتية.
إن ضرب المجتمعات بعضها ببعض في كنف هذا الفكر التكفيري، يضع أمريكا على منصة التحكيم وفي صورة الحليف والملاذ عوضاً عن العدو والخصم، وتلك غاية أمريكية تحققها "القاعدة"
غير أن مناهضة سياسات الهيمنة الأمريكية وإظهار العداء لها، بات في مناخ الإذعان الجمعي، ضرباً من "الفوبيا" يُعرِّض صاحبة للتقريع والاستهجان والاتهام بالجمود من قبل النخبة، على غرار فوبيا معاداة السامية في أوروبا.
وفي اليمن فإن حلبة التعددية السياسية لم تكن من التنوع بحيث تتسع لمكون سياسي يتبنى مناهضة أمريكا جدياً، وينحاز إلى صفوف الغالبية المفقرة ضد إملاءاتها الاقتصادية المقامرة بأقواتها لصالح استئثار القلة المسيطرة.
على خلفية هذه الأسباب مجتمعة اندلعت الحروب الست بعد إخفاق المحاربين بالوكالة، عبر الاعتقالات في لجم اختلاج الموجات الأولى الناجمة عن حجر المقاربة الجذرية الفذة الذي ألقاه السيد/ حسين بدر الدين في سكون المشهد المميت وسياميَّته، ليتأكد لقوى الهيمنة بعده أن ثمة آخر نقيضاً، لا مناص من القضاء عليه لاستتباب الهيمنة.
يؤكد الرئيس السابق علي عبد الله صالح في حواره مع قناة "العربية" 2013م، أن السلطة شنت الحرب بدءاً في "صعدة" ضد مسيرة بدر الدين على خلفية الصرخة، وبذلك فإنه يدحض كل الذرائع التي رافقت بدء العدوان وروَّج لها الإعلام الرسمي ووسائط "الميديا" التابعة للسلطة.
فــ "حسين بدر الدين" لم يـدَّع النبوءة، ولا أسقط العلم الجمهوري، ولا رفع علم إيران على أنقاضه، ولا دعا لمبايعته إماماً ولا سعى لطلب حصة هاشمية في الحكم من قبيل الأحقية السلالية ولا سواها من فبركات بلا حصر بررَّ بها المحاربون بالوكالة لما أسمَوه حروب الاجتثاث والأرض المحروقة.
لقد كانت تلك الحروب مبررة - فقط - لأنها استهدفت مكوناً هو على النقيض من كل مبرراتها المعلنة التي يجسَّـدها - بطبيعة الحال - المتذرعون بها، ليستوفي الصراع طرفيه - عن غير وعي من مسعِّريها - وتغدو طريق الثورة ممهدة لاحقاً لانضواء الشعب المقصي من حسابات لعبة الديمقراطية العقيمة، بتعدديتها الزائفة.
عكست إخفاقات المحاربين بالوكالة من جنرالات ورموز إقطاع عسكري وقبلي ومرتزقة وقاعديين، في صعدة، نفسها على الوضع العام للبلد بالضد لما تشتهي سفينة سلطة الحرب، إذ نضـَّــجت - بوتيرة مثابرة - الظروف الموضوعية لاندلاع ثورة، كان مناخ الاحتقانات الشعبية في الجنوب أكثر مسارحها خصباً وقابلية لترجمتها على الواقع في صورة اصطفافات نوعية جريئة انتظمت شتات المسرَّحين قسريا ً من عسكريين وأمنيين على خلفية حرب 1994م، وسرعان ما شرعت قوى اجتماعية أخرى من ضحايا الحرب وتداعياتها الكارثية، في تأطير صفوفها ومطالبها والانخراط في سلسلة متصاعدة من الاحتجاجات. وقد أصبح لهذه الأطر المطلبية النوعية مجلس جامع لاحقاً سمِّي مجلس التنسيق الأعلى لقوى الحراك الجنوبي، إحدى أبرز انجازاته النوعية تحقيق مصالحة جنوبية جنوبية تمظهرت في صورتها العملياتية الأخيرة من خلال مؤتمر التسامح والتصالح، الذي كان انطلاقه مطلع العام 2007م إيذاناً بانتقال الحراك المطلبي إلى طور ثورة شعبية ترمي لاستعادة الدولة الجنوبية عبر العمل السلمي.
لقد أفضت المقاربات غير الجذرية للأزمات المحلية المعقدة والمعضلات الوطنية المزمنة والمرحَّـله، على مصاف السجال بين المؤتمر الحاكم وائتلاف المشترك المعارض، إلى تنامي اليأس الشعبي من جدوى ديمقراطية الاقتراع وانعدام ثقة الغالبية في أهلية المكونات الحزبية التقليدية للنهوض بدور الموصِّـلات الجيدة لهاجس الشارع وأحلامه. . وبين محطة انتخابية وأخرى كان تعويل الجماهير على جدوى هذه اللعبة وحماسهم لها ينحسر. بيد أن استجابة الشارع في الشمال لما تفرضه سلسلة خيـباته المتلاحقة تلك، من ضرورة انتهاج مسار مغاير بأدوات غير تقليدية، كانت استجابة أبطأ بكثير مما هي عليه لدى الشارع الجنوبي ويرجع السبب في ذلك - باعتقادي - لسطوة البناء الاجتماعي البطريركي الذي تتكئ فيه الأحزاب على ثقل الجهويات التقليدية المسيطرة لتحقيق الحماية والحضور، فتتضاءل قدرة الفعاليات الشعبية المكبلة بالمحاذير على المبادرة واتخاذ القرار خارج نطاق سطوة هذه البطريركية، خلافاً لما هي عليه الحال في الجنوب حيث أسهمت تجربتا الاستعمار البريطاني ودولة النظام والقانون التي أرسى الحزب الاشتراكي قواعدها، في تقليص سطوة البناء الفوقي الأبوي لعلاقات مجتمع ما قبل الدولة على الأفراد.
كان جلياً أن الأزمة لم تعد أزمة حزب حاكم مع أحزاب معارضة فمنذ محطة الانتخابات الرئاسية والمحلية في 2006م كانت قد أصبحت أزمة بين طرفي المعادلة السياسية التقليدية الآنفين من جهة، وبين الشعب جنوباً وشمالاً من جهة مقابلة. وإذ يمكن تقرير ذلك بيسر فإن التكهن باندلاع حراك شعبي لم يكن يستلزم فرط إمعان في ملابسات المشهد المحتقن لتقرير أنه سيحدث حتماً.
إن الحراك الاجتماعي هو ردة فعل ناجمة عن فشل المؤسسة الحزبية السياسية في تنظيم وتعبئة قوى المجتمع لإحداث تغيير يلبي حاجاتها بطرق ناعمة حد تعبير علماء الاجتماع.
في محطة 2006م كانت أحزاب المشترك المعارض قد قررت إنهاء حالة المقاطعة وخوض الانتخابات الرئاسية المحلية، بعد حصولها على وعود من الاتحاد الأوروبي بالضغط على المؤتمر الحاكم لإجراء تعديلات دستورية تتيح الانتقال إلى نظام الانتخاب بـ "القائمة النسبية"، بدلاً عن نظام الدوائر، بالإضافة إلى إعادة هيكلة اللجنة العليا للانتخابات لضمان نسب تمثيل (عادلة) في قوامها الإشرافي، وهي مطالب ترفيّة بالقياس إلى درجة احتقان المشهد الشعبي وتآكل شرعية السلطة المتسارع بالنسبة لشارع جنوبي لم ترشح عن مكونات المشهد التقليدي الحاكم والمعارض، ردود فعل متفهمة إزاء مطالبه وخطورة العواقب المترتبة على إدارة الظهر لها.
أما الشمال فإن ترسانة القتل الجماعي الرسمية الناشطة في "صعدة" لم تكبح جماحها إلا على عتبة أقل من شهر على موعد الاستحقاق الانتخابي في سبتمبر 2006م، لتعاود مزاولة هوايتها المدمرة عقب هذا التاريخ بفترة وجيزة، لتكتمل فصول مسرحية الموت السداسية التي بدأت في 2004م بحرب هي الأخيرة، تالياً لآخر محطة من محطات لعبة الاقتراع.
سلب النضوج الشعبي الثوري المتنامي في الجنوب ونتائج الحروب الست في "صعدة"، سلطة 1994م شرعية الاستمرار في إدارة الحكم بذات الذهنية والأدوات واللافتات الحزبية المحتكرة لضفتي المشهد السياسي والتي ظلت تعيد ترميم وإنتاج شرعيتها عبر كواليس التسويات في الظل من صناديق الاقتراع وجماهير الناخبين، طيلة الفترة من 1997م حتى 2006م.
إثر ذلك بدت السنوات التالية من 2006م حتى 2011م، فترة من المراوحة، لجأت خلالها أحزاب الاقتراع إلى مواربة عجزها عن الذهاب إلى استحقاق 2008م البرلماني معاً أو فرادى، تلافياً لفقدان كامل الشرعية رسمياً على محك مشهد الحراك الجنوبي المشتعل، وبالتالي سقوط وحدة 7/7. . وفي الأثناء أدار طرفا المشهد السياسي الرسمي، الحاكم والمعارض، لعبة هي خليط من التهديد بمقاطعة الاستحقاق الانتخابي من قبل المشترك والتهديد المضاد من قبل المؤتمر بالذهاب الي الاستحقاق بصورة فردية أو بالتنافس مع أحزاب أخرى غير المشترك، وفي نهاية المطاف فقد كللت هذه اللعبة - التي استهدف طرفاها تبديد وقت الشارع للبحث عن فرص محتملة للخلاص من أزمتهما - بالتمديد التوافقي.
حاول الطرفان - بالتوازي للعبة شد الحبل الآنفة - الاستثمار في خضم الحراك الجنوبي بالانضواء التكتيكي تحت مطالبه السياسية على أمل امتطاء صهوة قيادته وتجييره لصالح سجالاتهما.
وقد وظَّفا في هذا السياق أوراقاً ووسائل شتى من بينها تغذية التناقضات المناطقية والجهوية في الصف الجنوبي - الجنوبي، شراء وتفريخ موالين في سدة قيادة الحراك، تعبئة وتجنيد (أجنحة القاعدة المتعددة وأمرائها) . . في غضون ذلك كانت أذرعة النفوذ البريطاني الأمريكي والسعودي كامتداد، حاضرة في قلب المشهد بأدواتها الجهوية التقليدية قديمة ومستحدثة، كما وبالوعود بتوفير أو عدم توفير غطاء لمطلب "فك الارتباط" وفقاً لما تقتضيه مصالحها.
لقد عزز موت المشهد الشعبي في الشمال، من قدرة الوكلاء المحليين المسيطرين وقوى الهيمنة الإقليمية والدولية على إحداث خروقات بليغة في طيف فعاليات الحراك الجنوبي، لا تزال قائمة إلى اليوم ويجري توظيفها في اللحظة الراهنة لإعاقة انتفاع القوى الحية فيه من متغيرات ثورة سبتمبر 2014م وهيأ التعاطي السلبي والمواقف العدمية لقيادة الحزب الاشتراكي منذ 2005م تحديداً حيال تطورات الأحداث في الجنوب، مناخاً ملائماً لنفاذ تلك الخروقات إلى مواقع حساسة في البناء الحراكي الوليد، وترجيح كفة قوى انتهازية قديمة وحديثة نهضت بأدوار رئيسة في خراب المشهد الجنوبي، على حساب ـطلائعه الثورية من يسار ووطنيين عركوا سيرورة الحراك الشعبي في أحرج وأشد لحظات مخاضه خطورة وكلفة.
ولا ريب أن إحدى أبرز المواقف العدمية لقيادة الاشتراكي على سبيل المثال الضغط على كوادره من ذوي المواقع القيادية في الأطر الحراكية لإنهاء ما وصفه الأمين العام للحزب بــ "حالة الازدواجية" التي يتعين معها - وفقاً لمنظوره - أن يختار الكادر أحد وضعين ويتخلى عن الآخر، ليكون إما قيادياً في الحزب أو قيادياً في الحراك لا الاثنين معاً.
لم يكن الخيار الثوري - بطبيعة الحال - خياراً محبَّذاً بالنسبة لقيادة أحزاب المشترك، التي ترى، تماماً كالمؤتمر الشعبي، أن الذهاب بلعبة المد والجزر بين معارضة وحكم، الى أبعد من حدود سجالات ساخنة من أجل تسويات مثلى في كنف رعاية دولية، سيفضي إلى انهيار معادلة الاحتكار الحصري التقليدية للُّعبة، لجهة بروز لاعبين آخرين يعكرون انسياب مصالح الراعي الدولي، أو يسلبون أطراف اللعبة العريقين امتيازات الحظوة لديه، وتبعاً لذلك اتسم لجوء ائتلاف المشترك المعارض، الاضطراري إلى توظيف الاحتقانات الشعبية على مصاف السجال التقليدي بالحذر الشديد وكبَّـل قواعده وأنصاره الذين احتشدوا في بضعة احتجاجات متقطعة دعا إليها بين 2007 ــ2010م، بسلسلة من التعليمات الصارمة والهتافات المقننة والخجولة فبزَّ ببراعته في لجم جماهير المحتشدين كل هراوات فرق الشغب في مخازن معسكرات الداخلية والأمن مجتمعة، وقد اقتصرت احتجاجات المشترك إبانها، على تنفيذ وقفات اعتصامية لا تتعدى الساعتين أو حفلات خطابية في استادات رياضية مغلقة، يعقبها تحذيرات عبر مكبرات صوت تهيب بالجماهير تنكيس اللافتات والانصراف راشدين في جماعات تسلك أكثر من طريق.
كان الشارع الشعبي إذاً محض "فزَّاعة" يلوِّح بها ائتلاف المشترك المعارض، في وجه الحاكم لكسب تموضع مريح وآمن في توازنات المشهد السياسي التقليدي. لذا فقد كان حريصاً - كل الحرص - على أن يقتصر دور هذه الفزَّاعة، في حدود أن تخيف، لا أن تنبض وتتحرك وتمتلك روحاً وإرادة وقراراً.
أراد - فحسب - أصنام تمرٍ يؤلهها ثم يلتهمها إذ يجوع، متعظاً من أسطورة ( تمثال بجماليون الحسناء) التي تمرَّدت على نحاتها الدميم ما إن تحققت دعواته بأن تدب فيها الحياة ليتخذ منها عشيقة حصرية، فتحولت إلى غصة قاتلة أجهزت عليه.
إن تداعيات الأحداث منذ اندلاع انتفاضة فبراير 2011م في الشمال وصولاً إلى مآلاتها، هي على وفرة من البراهين التي تكشف كنه علاقة المشترك، المتوجسة والمرتابة تلك بالشارع الشعبي.
إن فبراير 2011م ليس - بطبيعة الحال - موعداً سعيداً تأهَّب له ائتلاف المشترك، بنشوة عروس على تماس زفافها لمن تحب.
الحقيقة أن كِلا كفَّتَي المعادلة التقليدية قد ارتجفت تحت ثقل مقادير متكافئة من الذعر إزاء الانتفاضة لحظة اندلاعها، وكما تسلح الحاكم في وجهها بوسائط القمع المباشر المختلفة، فقد ضفرت المعارضة من أربطة عنق قياداتها مشانق ناعمة لها وطعنتها بذريعة الحماية في الظهر، وحزت رأسها لتضعها على منبر الوصاية الإقليمية الدولية، وتعود محملة بفرمان استحقاقها حصة حاكمة في وليمة تسوية مغلقة على حلقة الأيدي التقليدية ذاتها، دون جديد لجهة الشارع ومكوناته المقصية.
انتفض المغلوبون على أمرهم ليحرروا أقواتهم ومصائرهم من طائلة الوصاية والاستئثار باسم الشرعية الديمقراطية، فوقعوا تحت طائلة "الفصل السابع" باسم المبادرة الخليجية والإشراف الأممي على تنفيذها.
أما المقصيون من المشهد السياسي التقليدي المحتكر قبل 2011م، بحجة التمرد على الوحدة والنظام الجمهوري، فظلوا مقصيين بذريعة التخطيط لثورة مضادة مناهضة للمبادرة الخليجية ومعرقلة للوفاق، هكذا عثرت قوى السيطرة التقليدية المأزومة ومن ورائها مركز الهيمنة الدولي، في الانتفاضة التي أفزعتهم بداياتها على فرصة ثمينة للتداوي من مخاوفهم إزاء انفجار الاحتقانات الشعبية من خلال استفراغها في صورة متغيرات ثورية زائفة ومحض ديكورية، كما والخلاص من أزمة فقدان الشرعية عبر استدراج "أنصار الله" في الشمال وبعض مكونات الحراك الجنوبي، إلى طاولة حوار وطني تحت هراوات الفصل السابع، الأمر الذي أتاح لقوى السيطرة بالوكالة إضفاء شرعية على خارطة تقاسمات نفوذ فصَّـلتها المبادرة بتحوير طفيف على مقاس المعادلة العتيقة، ليكون مصير مخرجات الحوار المفتقرة لرافعة شراكة تنفيذية - لاحقاً - رهناً لمزاج القوى ذاتها تأويلاً وتنفيذاً بوصفها رافعتها الوحيدة والحصرية وبالمحصلة فإن حبر مخرجات الحوار لم يبرح أوراقها.
لقد أخـفـقـت تضحيات الشارع في أن تـثمر بلورة جادة لعقد شراكة حقيقية تشمل طيف المكونات الاجتماعية والسياسية وتمثل مصلحة الشعب على مختلف الصعد ـ وراهنت قوى السيطرة في حماية هذا الإخفاق المريح لها على حالة الإرهاق والاستنزاف التي لحقت بالشارع بامتداد عام من الانتفاضة في الشمال وأربعة أعوام جنوباً وتبعات ذلك الباهظة على شرائحه الاجتماعية المستنزفة أصلاً. .
إلى ذلك فقد اعتقدت هذه القوى بأنها وضعت للأبد خصومها من أنصارالله والحراك الجنوبي ، المناهضة لمآلات المبادرة والحوار، تحت الإقامة الجبرية المسيّجة بفولاذ التهديد بعقوبات أممية ضمن الفصل السابع، بحيث لن يصير بوسعهم إيقاظ فتنة الثورة النائمة، أو التفكير في تعبئة الشارع مجدداً باستثمار احتقاناته المتفاقمة، في مجابهةِ - ليس وكلاء محليين فحسب - بل مجتمع دولي بقواه العظمى المساندة لنشاز الوضع القائم هذه المرة ، الحقيقة أن هذه المعادلة الاحتكارية الموصدة أمام شراكة ندية جادة، بحكم المبادرة الخليجية والنهاية الاعتسافية لمؤتمر الحوار، كانت بالتوازي مفتوحة - وفقط - لصفقات شراكة بالتبعية والانضواء تحت إمرة شرطة الوصاية الدولية، بالنقيض لإرادة الشعب.
يفصح تصريح القائمة بأعمال السفير الأمريكي في صنعاء عقب استئناف أعمال مؤتمر الحوار في يناير 2014م، عن هذا المسار الخلفي المشبوه للشراكة، حيث تقول: "إذا انضم الحوثيون إلى أي حكومة تتشكل مستقبلاً، فإن عليهم أن يتخلوا عن توجهاتهم العدائية وإلا فإننا سنقاضيهم دولياً" وهو تصريح تداولته وسائل إعلام محلية وعربية على نحو احتفائي.
في السياق ذاته أظهر قيادي إخواني رفيع معارضة شديدة لشراكة محتملة مع أنصار الله، وقال بنبرة محتدة، خلال لقاء لتدارس ضمانات تنفيذ مؤتمر الحوار، حضره الدكتور أحمد شرف الدين عن انصار الله "لن نقبل أن تجمعنا بالحوثيين حكومة واحدة" وفي غمرة هذه النقاشات ذاتها أفاق الشارع اليمني على نبأ اغتيال الدكتور شرف الدين، كخاتمة دموية لحوار تعمَّــد في مرحلته الثانية بدم الدكتور عبدالكريم جدبان، وافتتح بمحاولة اغتيال عبد الواحد أبورأس التي راح ضحيتها شهيدان، وكلا العضوين - أبورأس وجدبان - ينتميان لقائمة ممثلي أنصار الله، في حين شهد مطلع المرحلة الأخيرة من عمر مؤتمر الحوار إقصاءً فجّاً للمكون الوحيد بين مكونات الحراك الجنوبي، الذي قبل الانخراط ضمن فعالياته، وتم تفريخ بديل مرتجل ليحل محله عبر بذل المال السياسي والتعيين في مناصب حكومية متقدمة، إلى ذلك كله فإن السلطة المحتكرة للقرار السياسي ماطلت في تنفيذ ما اتفق عليه كإجراءات وحلول مهيئة للشروع في الحوار، والتي عرفت بالنقاط الإحدى عشر والعشرين ، المتعلقة بقضيتي - صعدة والجنوب -، واستمرت في نكوصها عن الإيفاء بها خلال انعقاد الحوار وبعده، فيما كان يمكن لــ ( فيدرالية من إقليمين جنوبي وشمالي بحدود ما قبل 1990م ) أن تمثِّل توجهاً جاداً ومطمئناً بالنسبة لشارع جنوبي محتقن ويعتقد بعدم جدوى الحوار بالإطلاق، فقد انتزعت رئاسة الجمهورية وحكومة الوفاق تخويلاً قسرياً من بعض مكونات الحوار، قررت على إثره تدشين مشروع فيدرالية من ستة أقاليم، إقليمين جنوباً وأربعة شمالاً، علاوة على تمديد رئاسي جديد، خارج الاجماع.
لقد توَّجت السلطة - بطبيعة الحال - سلسلة مقامراتها تلك وأدائها الارتجالي الغير آبه بحساسية الوضع العام للبلد وانصرام حبل التعويل الشعبي، بقرار إصلاحات سعرية على مصاف المشتقات النفطية، كان - بالإجماع - أكثر القرارات جوراً واجتراء على امتداد تاريخ إعادة الهيكلة والإصلاحات الاقتصادية التي شرعت اليمن في تنفيذها من 1990م.
كان ذلك كفيلاً بدفع الشارع لاسيما في الشمال مجدداً إلى أتون الخيار الثوري، بوصفه - في أسوأ الأحوال خيار شمشون - أو مقاربة راديكالية باهظة لاجتراح أفق حياة أوفر آدمية، في أحسن الأحوال، وكان لدى مكون أنصار الله الأهلية وذات القدر من الأسباب والحوافز التي تدعوه لريادة مشهد شعبي بات آيلاً تماماً للذهاب إلى انتفاضة أخرى إثر قرابة أربعة أعوام من تداعيات انتفاضة فبراير 2011م المخيبة للآمال.
خــــــــاتــــــــــمة
أخفقت انتفاضة فبراير 2011م في تحقيق المرجو منها ووقعت في مستنقع المحاصصة بالاسـتـئـثـار ومزاد الوصاية الدولية. . لكنها طرحت أمام أنصار الله، لحظة تاريخية ناضجة لكسر أسجية العزلة التي فرضتها عليه ملابسات ست حروب طاحنة وشديدة الجور، فبات قادراً على الاتصال المباشر بطيف المكونات الاجتماعية الشعبية والحزبية على نطاق واسع، ومعالجة الصورة النمطية المسوَّقة سلباً عنه، في الخطاب الإعلامي الرسمي المواكب للحرب.
حيث برع أنصار الله - على نحو مذهل - في اغتنام نضوج اللحظة، وتمكنوا في غضون بضعة أشهر على بدء الانتفاضة من مدِّ وشائج حضور فارق بطول وعرض الخارطة، وكانوا بشهادة كثيرين بما فيهم بعض خصومهم، رقماً نوعياً في قلب الانتفاضة الشعبية على مصاف التنظيم والتأثير والتفاعل الإيجابي السلس مع شتى شرائحها ومكوناتها.
بمقدورنا القول إن شهور الانتفاضة قد أنضجتهم سياسياً - على محك الممارسة العملية وجدل الاختلاف - بالقدر الذي أنضجتهم سنوات الحرب عقائدياً وعسكرياً، كانت هاتان التجربتان بمثابة جناحين تخلَّقـــا وتصالبا في غمار تجارب قاسية استحقت أثمانها الباهظة كما أثبتت السنوات اللاحقة التي تموضع خلالها أنصار الله في قلب معادلة سياسية، اجتهد خصومهم في إدامة محبوسيتهم - ليس على هامشها فحسب - وإنما على هامش الحياة بالمطلق وكان هذا المخاض الذي شهد أبرز أطواره في انتفاضة سبتمبر 2014م ـ يعني تغيراً نوعياً في طبيعة معادلة الحكم التقليدي في اليمن، لا متغيراً كمياً مضافاً اليها كما يعني تغـيُّـراً في خارطة علاقات الجوار الإقليمي والدولي باليمن سلباً وايجاباً، وفي هذا السياق - عقب توقيع اتفاقية السلم والشراكة التي لم تستثن أحداً على نقيض المبادرة الخليجية وردود الفعل الخارجية السلبية منها - أكد السيد عبد الملك الحوثي أن الحركة ليس لديها أعداء حصريين ولا أصدقاء حصريين، باستثناء - قوى الهيمنة والكيان الصهيوني - وأنها مفتوحة على ما يحقق مصلحة اليمن وشعبها، في سيادة كاملة وعلاقات ايجابية لاتبعية فيها ولا وصاية لأحد، والحقيقة أن هذه المحددات التي أكدها السيد/ عبدالملك، هي ما يسعى ويناضل لتتحقق على مصاف الكينونة الوطنية المنشودة، كل الوطنيين بامتداد تاريخ اليمن الحديث، وليست محددات تعني أنصار الله حصراً.
لقد كان لخطاب الحركة في أذهان الناس خلال انتفاضة 21 سبتمبر، صدى شبيه الأثر وقريب الصلة، بزخم سنوات حكم الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي، ما يعني اتصالاً مديداً بسيرورة الحلم الشعبي التي انقطعت تماماً في 7/7/ 1994م وتنكرت لها المكونات السياسية عقب ذلك على مصاف الخطاب والسلوك لوصفها محالات غير قابلة للتحقيق. .
سددت انتفاضة سبتمبر 2014م ضربات قاصمة وجذرية لمنظومة لصوص الحلم الوطني على امتداد محطاته شمالاً وجنوباً. . الأمر الذي بَرهن على أن ريادة المشترك لانتفاضة فبراير 2011م، في ذروة معطياتها لم تكن أكثر من مناورة، واربت ثلثي جبل جليد السلطة ومنظومتها خلف الانتفاضة وساقتها باتجاه مجابهة عبثية مع واجهة السلطة الديكورية وغير المفصلية. . لتعيد إنتاج منظومة الظل بشرعية ثورية زائفة في دلالة عملية على أن التغيير المنشود لا يمكن أن ينجم من احتدام صراع غير تناحري بين متجانسين مرتهنين لذات المقاربات الخارجية على مختلف الأصعدة. . وعليه فإنه لكي تترقى أحداث 21 سبتمبر من انتفاضة إلى ثورة يتعين أن يتشبث أنصار الله الطليعة الثورية بمقاربات جذرية لقضايا من قبيل النظرة للعدالة الاجتماعية والشراكة، وطبيعة الدولة، والحريات العامة والشخصية، وقبل ذلك مقاربتهم للقضية الجنوبية التي ما كان بمقدور مكونات الحراك الجنوبي الحية والصادقة أن تقف على عتبة حلول مفتوحة وفسيحة لها اليوم، لولا تهاوي رؤوس الإقطاع في الشمال وأمراء 7/7/1994م، بفضل انتفاضة 21 سبتمبر. . يتعيَّـن إذاً أن تكون هذه الانتفاضة جسراً تعبر من خلاله القضية الجنوبية إلى ضفة حلول ناجعة وناجزة، لا جسراً لتجاوزها كما أرادت قوى السيطرة التقليدية لانتفاضة فبراير 2011م أن تكون، حين راحت عقب استتباب مصالحها تلقم الشارع الجنوبي بالقوة شعارات ساذجة على غرار - الوحدة قدرنا، نجوع ولا نفرط بالوحدة - استمراراً لذهنية 7/7 وإكليشتها الأشهر إبان حرب الفيد، "الوحدة أو الموت".
لا ينبغي أن يصبح 21 سبتمبر مسوغاً لمطالبة الشارع الجنوبي المنتفض بأنْ اصمتوا إلى الأبد، فلا حاجة للصراخ بعد الآن، لمجرد أن أبرز قوى الفيد قد تهاوت، لقد أفسح هذا التاريخ الفذ سبيلاً مذللة لحلول جذرية، لكنه لم يطرح حلولاً بعد قـوَّض منظومة، لكنه لم يطرح رؤيته بسطوع لبديل نقيض، يترقبُ غالبية الشعب أن ترتفع قواعده على أطلال البائد شمالاً وجنوباً ، بيد أن من المهم هنا تأكيد أن ما جرى تقويضه بالشعب ومع الشعب، يستحيل بناء نقيضه إلا بالشعب ومع الشعب ولمصلحته، وعدا ذلك فإنه لا قوة ولا شرعية لأي بديل ينبني خارج هذا الخضم ولا يعكس تطلعاته.
إن كل معادلة يسقط منها الشعب عمداً أو سهواً وطرفاً أو نتيجة، هي محض صفقة مشبوهة سيسقطها الشعب كما أسقط سالفتها، ولا استثناء على أرضية هذه الحتمية لجنوب أو شمال بدعوى الخصوصية، إذ أنه لا إمكانية لوحدة أو لفك ارتباط دون شراكة تثمن المصلحة الشعبية في مقاربتها للحلول.
إن المقاربة الأمريكية البريطانية التي تفرز البنى الاجتماعية بمنظور تفكيكي إلى بضعة هويات انعزالية متخيلة مناطقياً ومذهبياً وعرقياً، هي مقاربة تستهدف الشعب بوصفه المشكلة، وبالنتيجة فإن استئصاله يغدو الحل الأمثل من وجهة نظرها وتتلخص هذه المقاربة في صورة مشروع الأقاليم الستة، الذي حالت متغيرات 21 سبتمبر دون المضي فيه، مفسحة المجال لمقاربات أخرى وطنية، لم تتخلق حتى اللحظة، بفعل حالة المراوحة في مناخ هجين ناجم عن استمرار معظم الأطراف المنضوية في اتفاقية السلم والشراكة، في تعويلها ـ بالقصور الذاتي ـ على مظلة الوصاية الخارجية ومدد الفصل السابع.
في الأثناء فإن نتائج قرابة نصف قرن من التبعية الاقتصادية المكرسة وهشاشة مؤسسات الدولة لاسيما العسكرية والأمنية منها، تبدو أوراقاً رابحة توظفها معظم دول الجوار النفطي وقوى الهيمنة الدولية بصورة غير مسبوقة في حربها على اليمن ما بعد 21 سبتمبر، بهدف كبح الانهيار المتسارع لمنظومة نفوذها التقليدي والسعي لاستعادة ما انحسر من نفوذ، عبر تجييش الشارع الشعبي والزج به في مواجهة مع قواه الثورية، تحت وطأة يأسه المتفاقم من تحسُّن الأوضاع الاقتصادية وجحيم الانفلات الأمني، احتياطي اليمن من العملة الصعبة على وشك النفاذ، وتيرة محاربة الفساد بطيئة، والعائدات أقل بكثير من الحاجة، السعودية تعلق مساعداتها الاقتصادية، والقاعدة تضرب في كل مكان من أنابيب النفط في مأرب إلى سكن السفير الإيراني في صنعاء.
إن حاجة أنصار الله السياسية للانخراط في تسويات ثنائية على نحو تسويته مع الإصلاح مثالاً، في مقابل عدم إنجاز تحالفات تضم مكونات ثورية جديدة غير تقليدية إلى جواره، هي متلازمة تفصح عن جَزْر ثوري تضطر معه الحركة للانكفاء إلى مسار تسووي تقليدي.
وثمة متلازمة أخرى تعمل بالتوازي مع الآنفة، وتتمثل في حاجة أنصار الله - كطليعة ثورية - إلى الانتشار العسكري "اللجان الشعبية" على مساحة شاسعة من الجغرافيا لتأمين مصدات حمائية متقدمة تستهدف ضرب البؤر الرئيسية لتنظيم القاعدة، وشلّ قدرتها على نقل المواجهة إلى قلب العاصمة صنعاء، كما وتوفر غطاءَ أمنياً لنشاط قواعدها والفعاليات الثورية الأخرى الحليفة لها في محافظات الأطراف، بالنظر إلى الغياب شبه الكامل لدور الأجهزة الأمنية والعسكرية الرسمية على هذا المصاف، لأسباب هي خليط من عجز بنيوي وعقدي علاوة على تواطؤ وقصدية.
بالنتيجة فإن الحركة تضطر إلى استضافة قوة كمية على حساب النوع، في قوامها العملياتي الميداني لتغطية حاجتها إلى الانتشار الواسع ذلك.
وتُظهر اللجان الشعبية المسلحة فدائيةً وجلَداً شديدين يوجب الإشادة بدورها، فعلاوةً على التضحيات اليومية الجسيمة التي تقدمها في معاركها الضارية مع عصابات إجرامية دولية محترفة من شذاذ الآفاق، تقف هذه اللجان مكابرة بظهر تثخنه ماكنة بروبجندا معادية رهيبة ولا أخلاقية، بطعنات الشائعات المسمومة والقصص المفبركة التي تنال من شرف أفرادها على مدار الساعة.
إن حركة أنصار الله تنوء وحيدة بعبء التبعات الباهظة لحقائق هذا الخناق الجيوسياسي المطبق على عنق البلد والمتوثب لكسرها كلما حاولت أن تشرئب مستشرفة أفق خلاصها، لكن جلاوزة هذا الخناق من قوى داخلية وخارجية، يدركون جيداً أن اليمن قد شبَّت على الطوق وأن خناق الوصاية على وشك الانحسار تدريجياً.
إن ندرة القيادات التاريخية اليمنية التي اقتحمت خطوط المحاذير الحمراء لهذا الخناق غير هـيَّـابة وناءت بتبعات الشروع في مجابهة مفتوحة معه، هوما يجعل الحركة تبدو وحيدةً اليوم، إنها تقف حيث وقف عبد الرقيب عبد الوهاب، وعبود الشرعبي، ومدرم وسالمين والحمدي، وعبد الفتاح إسماعيل وكل رموز ذلك الرتل الطويل ممن وقفوا حيث لا يجرؤ أحد على الوقوف، وحرثوا خنادق نضالهم لبذرة الحلم الوطني، فاستشهدوا مُضمخين بطين وعرق سواعد الغالبية الكادحة والمستضعفة من حوف إلى مران ومن سحول ابن ناجي إلى وادي مأرب ، هكذا هم أنصار الله اليوم في عيون غالبية تنظر اليهم بوصفهم استمراراً لما انقطع من تواريخ وطنية مشرقة وحافلة بوعود الخلاص، واتصالاً حميماً بضمائر لم يستوحش أصحابها طريق الحق لقلة سالكيها.
إن المستغرقين في تفاصيل مجهرية يومية عابرة، ليس بوسعهم أن يفطنوا للحقائق التاريخية الكبرى في طور تخلُّـقها الأول، لأنهم لا يستشرفون أفق الصراع الرحب، وتماس المجابهة المديد، فيمعنون في العُلِّيق ولا يرون السنديانة ويرون الشجرة ولا يرون الغابة.
أما الخصوم ممن لا يلتزمون قواعد اشتباك وطنية في خصومتهم، فإنهم لا يرون إلا هزيمتهم في انتصار الشعب، ويستحيلون أصفاراً عندما تصبح اليمن رقماً فارقاً في ميزان القيمة على مصاف صراع الكينونة.